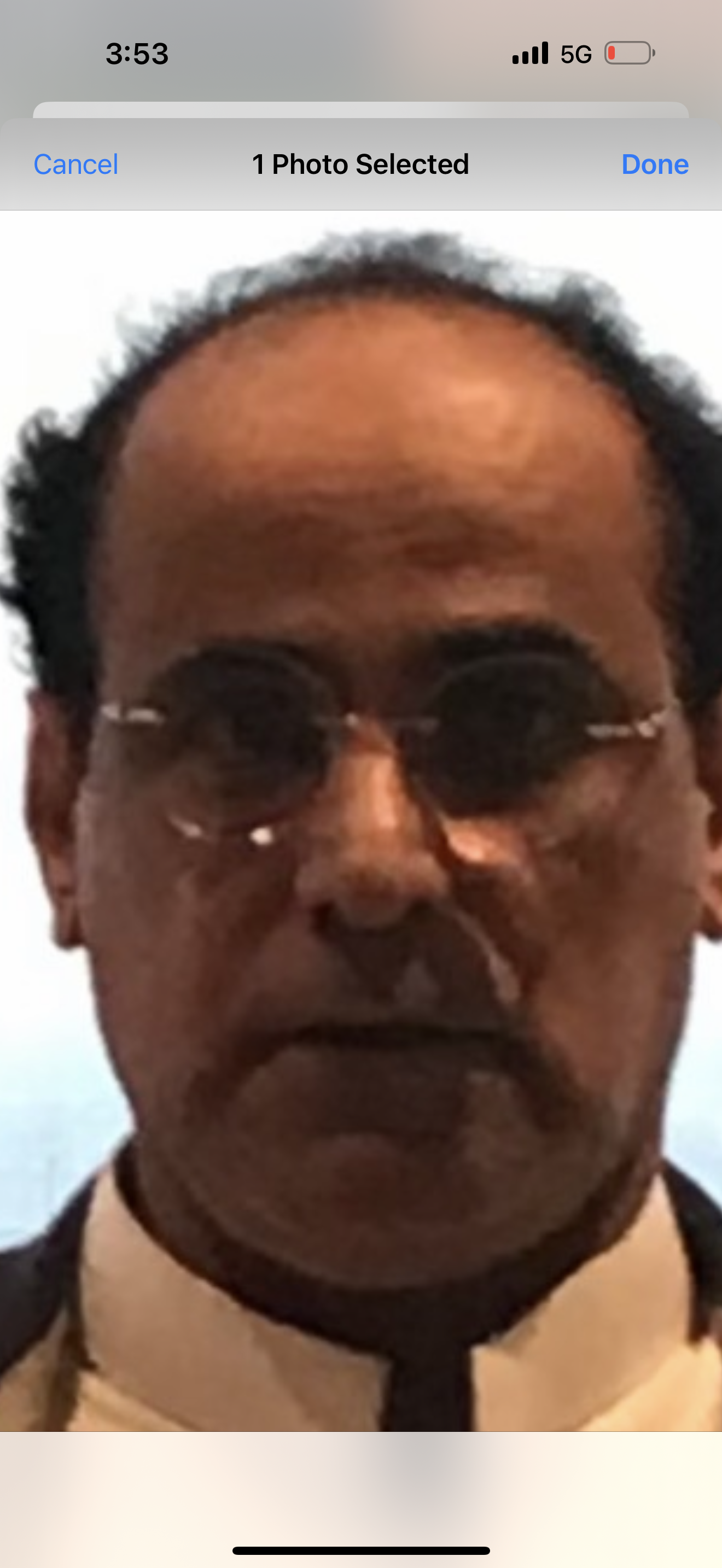اليمن بين خيار الوحدة … و مخاوف الانفصال
يذهب بعضهم إلى الاعتقاد بأن انفصال اليمن إلى شمال وجنوب بات خيارًا سهل التحقيق، أو حلًا جاهزًا للأزمة اليمنية المركّبة، غير أن هذا الطرح يغفل تعقيدات تاريخية واجتماعية وسياسية عميقة تشكّلت عبر عقود طويلة. فبعد ما يقارب أربعين عامًا من الوحدة، لم يعد الحديث عن الانفصال مجرد قرار سياسي أو إجراء إداري، بل تحوّل إلى مسألة تمس جوهر النسيج الاجتماعي اليمني، وتحمل في طياتها عواقب خطيرة على السلم الأهلي والاستقرار الوطني والإقليمي.
وقبل قيام الوحدة، ورغم وجود كيانين سياسيين، كان اليمن في جوهره واحدًا: وحدة في الدين، واللغة، والعادات، والتقاليد، والبنية الاجتماعية. وجاءت سنوات الوحدة لتُعمّق هذا الانصهار الطبيعي، من خلال التزاوج، والمصاهرة، وتشابك المصالح الاقتصادية والاجتماعية، وتداخل الهويات المحلية، الأمر الذي جعل أي محاولة للفصل القسري بين الشمال والجنوب اليوم بالغة التعقيد، إن لم تكن مستحيلة دون أثمان إنسانية وسياسية باهظة.
ومن أبرز الشواهد على وحدة المصير، وقوف اليمنيين شمالًا وجنوبًا في مواجهة انقلاب جماعة الحوثي على الدولة والشرعية. فقد شكّل ذلك الموقف محطة مفصلية عبّرت عن إدراك جمعي بأن الخطر الذي يهدد الدولة اليمنية لا يميّز بين منطقة وأخرى. ومن هذا المنطلق، تبدو دعوات الانفصال، خصوصًا في ظل هذا السياق، موضع تساؤل أخلاقي وسياسي، لما تحمله من تنكّر لتضحيات مشتركة قدّمها أبناء اليمن في مختلف المحافظات.
وفي المقابل، لا يمكن إنكار وجود مظالم حقيقية في الجنوب، وشعور متراكم لدى قطاعات واسعة بالتهميش وسوء إدارة الدولة بعد الوحدة. وهي مظالم أسهمت في صعود حركات احتجاجية تطالب بتصحيح مسار الوحدة، أو بإعادة صياغتها على أسس عادلة. غير أن تحويل هذه المطالب المشروعة إلى مشروع انفصال يُفرض بالقوة، أو يُدار بمنطق الغلبة، يحمل مخاطر تفوق بكثير ما يُروّج له من مكاسب. فالتجارب الإقليمية والدولية تؤكد أن الانفصال في مجتمعات منقسمة لا يُنتج استقرارًا، بل يفتح الباب أمام صراعات داخلية جديدة، ويُضعف بنية الدولة، بدلًا من إصلاحها.
وفي هذا السياق، يُنظر إلى ممارسات المجلس الانتقالي الجنوبي بوصفها عاملًا إضافيًا في تعميق الانقسام داخل الجنوب ذاته. فمحاولاته فرض رؤيته بالقوة السياسية أو العسكرية أسهمت في إضعاف الجبهة الجنوبية الداخلية، وخلقت انقسامات واضحة بين أبنائه، كما هو الحال في حضرموت والمهرة، حيث تبرز مواقف رافضة لهيمنته ومخططاته. ويثير هذا الواقع مخاوف حقيقية من انزلاق اليمن إلى نماذج دول تفككت بفعل تعدد مراكز النفوذ، وغياب مشروع وطني جامع، وتحول السلاح من أداة حماية إلى وسيلة صراع داخلي.
ويزداد القلق مع استمرار محاولات المجلس الانتقالي بسط نفوذه على حضرموت والمهرة، لما لهاتين المحافظتين من أهمية جغرافية واقتصادية واستراتيجية. ولا تقتصر هذه المساعي على الأدوات العسكرية والأمنية، بل تشمل تحركات سياسية ودبلوماسية معقّدة تهدف إلى فرض أمر واقع، يتيح التفاوض من موقع قوة، داخليًا وخارجيًا، دون تفويض وطني جامع أو توافق محلي حقيقي.
وتشير بعض التحليلات إلى أن هذه التحركات تأتي ضمن مساعٍ لعقد صفقة سياسية غير معلنة مع جماعة الحوثي، تقوم على مبدأ تقاسم النفوذ: جنوب يخضع لسيطرة الانتقالي، وشمال تحت هيمنة الحوثي، مقابل إرضاء أطراف إقليمية ومحلية مؤثرة، واستخدام أدوات الضغط أو الإغراء السياسي والمالي لضمان القبول أو الصمت، حتى وإن كان ذلك على حساب القيم الوطنية والمبادئ الجامعة.
غير أن هذا المسار يطرح سؤالًا جوهريًا لا يمكن تجاهله: هل يمكن الوثوق بجماعة الحوثي، وهي حركة دينية عقائدية ذات مشروع توسعي، أن تلتزم بحدود جغرافية أو باتفاقات تقاسم نفوذ؟ فالتجربة العملية منذ حروب صعدة، مرورًا بانقلابها على الدولة، تؤكد أن الحوثي لا ينظر إلى السلطة كشراكة وطنية، بل كغنيمة، ولا يؤمن بمنطق الدولة الوطنية، بقدر إيمانه بمشروع أيديولوجي يتوسع كلما سنحت له الفرصة.
وعليه، فإن أي رهان على قبول الحوثي بدولة جنوبية مستقلة، أو بحدود فاصلة دائمة، يبدو رهانًا محفوفًا بالمخاطر، وقد يقود في نهاية المطاف إلى صراع جديد لا يقل شراسة عن الصراع القائم، بل ربما أشد تعقيدًا، لأنه سيكون صراعًا بين مشاريع مسلحة متنافسة، لا بين دولة وجماعة متمردة.
كما أن الطروحات التي تلمّح إلى تقاسم البلاد بهذا الشكل أثارت قلقًا واسعًا في الأوساط الدولية، لما تحمله من تهديد مباشر لأمن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، وللاستقرار الإقليمي عمومًا، وأسهمت في تقويض الثقة الدولية بالقيادات التي تطرحها، بدلًا من تعزيز فرص الحل السياسي الشامل.
وفي المحصلة، يظل خيار الحفاظ على وحدة اليمن، مع إجراء إصلاحات جذرية تعالج المظالم، وتعيد بناء الدولة على أسس العدالة والشراكة والإنصاف، أقل كلفة وأكثر أمانًا على المدى البعيد من خيار الانفصال. فالوحدة ليست شعارًا سياسيًا جامدًا، بل مسؤولية تاريخية تتطلب شجاعة في النقد، وصدقًا في المعالجة، وحوارًا وطنيًا جامعًا، وتغليب مصلحة اليمنيين جميعًا على المصالح الضيقة، حفاظًا على السلم والاستقرار، ومنعًا لمزيد من الانقسامات والدماء.