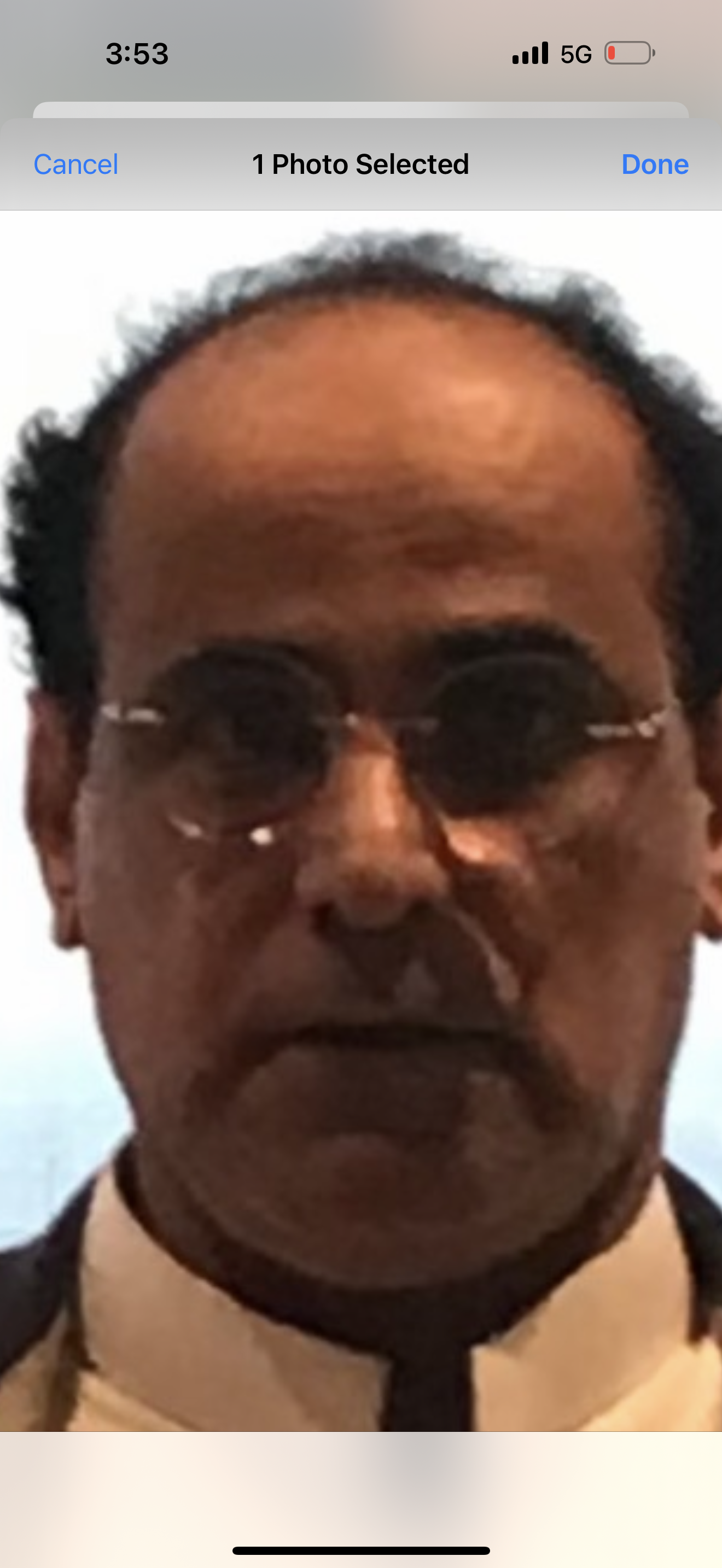الجغرافيا أولًا: حدود التدخل، ووهم تصدير الأجندات، ومفارقة دعم الانفصال
تتكوّن دولة الإمارات العربية المتحدة من سبع إمارات: أبوظبي، دبي، الشارقة، الفجيرة، عجمان، رأس الخيمة، وأم القيوين. وقد نشأ هذا الكيان الاتحادي عبر مسار سياسي بالغ الحساسية، بدأ عام 1968، وتوّج بإعلان الاتحاد عام 1972، ثم تعزّز بتوحيد القوات المسلحة عام 1976. ولم يكن هذا التوحيد تفصيلًا إداريًا، بل استجابة مباشرة لهواجس التفكك، ومحاولة واعية لتحصين كيان اتحادي وُلد في بيئة إقليمية مضطربة، كانت ولا تزال تعجّ بالانقسامات والانهيارات.
اليوم، يواجه الاتحاد الإماراتي تحديًا بنيويًا لا يمكن تجاهله: تركيبة سكانية مختلّة بعمق، إذ يشكّل المواطنون الإماراتيون نحو 11% فقط من إجمالي السكان البالغ عددهم قرابة 11 مليون نسمة. وهذا الواقع لا يُعدّ مسألة ديموغرافية عابرة، بل إشكالية سيادية تمسّ جوهر الدولة، وهوية المجتمع، واستدامة العقد السياسي على المدى الطويل.
وانطلاقًا من هذه الهواجس، تبنّت أبوظبي، بوصفها مركز القرار والثقل السياسي، سياسات انفتاح اقتصادي وديموغرافي واسع، خصوصًا في أبوظبي ودبي، ما أدّى إلى تركّز غير مسبوق للثروة والنفوذ في هاتين الإمارتين. غير أن هذا التركّز لم يكن بلا كلفة، إذ خلق فجوة داخلية واضحة، وحوّل بعض الإمارات الأخرى إلى أطراف ملحقة اقتصاديًا، رغم أنها كيانات سياسية ذات تاريخ وشرعية اجتماعية عميقة، يحكمها شيوخ ينتمون إلى أسر مؤسسة، لا إلى إدارات وظيفية.
إن تجاهل هذا الاختلال، أو التقليل من مخاطره، يُعدّ قصر نظر استراتيجي. فالاتحادات لا تُدار بمنطق المركز المتغوّل والأطراف الصامتة، بل بمنطق الشراكة المتوازنة. وأي شعور مستدام بالتهميش أو التفاوت في النفوذ قد يعيد، عاجلًا أو آجلًا، طرح أسئلة محرّمة حول معنى الاتحاد وحدوده، وهي أسئلة لا تُعالج بالقوة الاقتصادية ولا بالردع الأمني، بل بالعدالة السياسية.
في هذا السياق، يصبح التدخل الإماراتي في الشأن اليمني – ولا سيما دعم مشاريع سياسية ذات طابع انفصالي – مفارقة صارخة. فكيف لدولة اتحادية قامت أساسًا لمواجهة خطر التفكك، أن تنخرط في تغذية نزعات التفكك خارج حدودها؟ وكيف لمن يخشى على وحدته الداخلية أن يغامر بتطبيع الانقسام كأداة سياسية في دولة أخرى ذات سيادة؟
اليمن ليست دولة حدودية مباشرة مع الإمارات، ولا تشكّل امتدادًا جغرافيًا عضويًا لها، ما يجعل هذا التدخل تجاوزًا صريحًا لمنطق الجغرافيا السياسية، ومساسًا بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. فالقضايا المصيرية، كالوحدة أو الانفصال أو شكل الدولة، لا تُقرَّر عبر التمويل أو التسليح أو الرعاية السياسية الخارجية، بل عبر إرادة وطنية جامعة تعبّر عن الشعب اليمني نفسه، لا عن توازنات إقليمية عابرة.
ومن منظور أكثر صرامة، فإن إدارة أزمات الجوار يجب أن تنطلق من قاعدة واضحة: الدول الحدودية هي الأَولى بتحمّل عبء الحل، لا الدول البعيدة جغرافيًا. فالجغرافيا ليست رأيًا سياسيًا، بل قدرًا استراتيجيًا. ويظهر هذا المبدأ بجلاء في القضية الفلسطينية، حيث تقع المسؤولية المباشرة – سياسيًا وأمنيًا وإنسانيًا – على عاتق دول الطوق، وفي مقدمتها الأردن ومصر ولبنان، بحكم الحدود، واللاجئين، والتداخل السكاني، وتأثير أي انفجار في الصراع على أمنها القومي.
أما الدول البعيدة، سواء في المغرب العربي أو الخليج أو حتى في العالم الإسلامي الأوسع، فليس من حقها فرض مقاربات أو شعارات أو ضغوط سياسية على دول الطوق، ولا الزجّ بها في مغامرات تتجاهل تعقيدات الواقع الذي تعيشه هذه الدول يوميًا. فالتضامن لا يعني الوصاية، والدعم لا يبرّر فرض الأجندات.
إن دعم النزعات الانفصالية خارج الحدود، تحت أي ذريعة كانت، يضرب أسس النظام الإقليمي، ويقوّض مبدأ السيادة، ويخلق سوابق خطيرة سرعان ما ترتدّ على أصحابها. فلا يمكن لدولة أن تطالب بتحصين وحدتها الداخلية، ثم تسعى في الوقت ذاته إلى تفكيك دول أخرى. فالتاريخ لا يكافئ من يلعب بالنار، والجغرافيا لا تنسى.