-
الانضمام إلى فريقنا
info@saudisoccervoting.com -
إتصل بنا
comments@saudisoccervoting.com
Schedule
-
Match To Be Played On Feb 19, 2026 10:00 PM

الخلود
الرسV/SMatch CenterMatch Highlights
الرياض
الرياض -
Match To Be Played On Feb 19, 2026 10:00 PM

الإتفاق
DammamV/SMatch CenterMatch Highlights
الفتح
Al-Hasa -
Match To Be Played On Feb 19, 2026 10:00 PM

الأهلي
JeddahV/SMatch CenterMatch Highlights
النجمة
عنيزة -
Match To Be Played On Feb 20, 2026 10:00 PM

الاخدود
نجرانV/SMatch CenterMatch Highlights
القادسية
الخبر -
Match To Be Played On Feb 20, 2026 10:00 PM

التعاون
BuraidahV/SMatch CenterMatch Highlights
الفيحاء
Al Majma'ah -
Match To Be Played On Feb 20, 2026 10:00 PM

ضمك
خميس مشيطV/SMatch CenterMatch Highlights
الشباب
Riyadh -
Match To Be Played On Feb 21, 2026 10:00 PM

الهلال
RiyadhV/SMatch CenterMatch Highlights
الإتحاد
Jeddah -
Match To Be Played On Feb 21, 2026 10:00 PM

النصر
RiyadhV/SMatch CenterMatch Highlights
الحزم
Ar Rass -
Match To Be Played On Feb 21, 2026 10:00 PM

الخليج
سيهاتV/SMatch CenterMatch Highlights
نيوم
نيوم
-
- Feb 19, 2026 10:00 PM
-
-

- 0
- :
- 0
-

- الخلود
- VS
- الرياض
- Alhazm Club Stadium
-
-
- Feb 19, 2026 10:00 PM
-
-

- 0
- :
- 0
-

- الإتفاق
- VS
- الفتح
- ملعب ايجو
-
-
- Feb 19, 2026 10:00 PM
-
-

- 0
- :
- 0
-

- الأهلي
- VS
- النجمة
- ملعب الأمير عبدالله الفيصل
-
-
- Feb 20, 2026 10:00 PM
-
-

- 0
- :
- 0
-

- الاخدود
- VS
- القادسية
- مدينة الامير هذلول الرياضية
-
-
- Feb 20, 2026 10:00 PM
-
-

- 0
- :
- 0
-

- التعاون
- VS
- الفيحاء
- ملعب التعاون
-
-
- Feb 20, 2026 10:00 PM
-
-

- 0
- :
- 0
-

- ضمك
- VS
- الشباب
- prince sultan sport city
-
-
- Feb 21, 2026 10:00 PM
-
-

- 0
- :
- 0
-

- الهلال
- VS
- الإتحاد
- KINGDOM ARENA
-
-
- Feb 21, 2026 10:00 PM
-
-

- 0
- :
- 0
-

- النصر
- VS
- الحزم
- الاول بارك
-
-
- Feb 21, 2026 10:00 PM
-
-

- 0
- :
- 0
-

- الخليج
- VS
- نيوم
- Prince Mohamed bin Fahd Stadim
-
Peoples Choice صوت الآن

المجلس الانتقالي: من وهم الوطنية إلى تنفيذ الأجند...
الوطني لا يطعن وطنه في خاصرته، ولا يستقوي بالخارج لتصفية حساباته الداخلية. ما يفعله عيدروس الزبيدي وهاني بن بريك ومن يدور في فلكهما ليس “خلافًا سياسيًا” ولا “رؤية مختلفة”، بل هو انخراط صريح في حملة تشويه ممنهجة ضد اليمن، تقوم على تلفيق تهم الإرهاب وربط البلاد بالقاعدة و”الإخوان”، في محاولة يائسة لإضفاء شرعية زائفة على مشروع فشل عسكريًا وسياسيًا وأخلاقيًا.
لقد سقطت كل الذرائع التي رُفعت سابقًا، ولم يعد خافيًا أن الهدف لم يكن يومًا “تحريرًا” ولا “استعادة دولة”، بل السيطرة على القرار اليمني ومقدراته، وعلى رأسها الموانئ والجزر والمواقع الاستراتيجية. وحين فشلت هذه الأدوات في فرض واقع دائم، تحركت الآلة الإعلامية الإماراتية بكل ثقلها لإعادة إنتاج الأكاذيب، وتصوير اليمن كأرض فوضى وإرهاب، تمهيدًا لتبرير أي تدخل قادم أو عبث جديد.
وأي اضطرابات أو حوادث أمنية قد تشهدها اليمن بعد الانسحاب الإماراتي لن تكون صدفة ولا نتيجة فراغ، بل امتداد مباشر لأجندة تخريبية معروفة، هدفها زعزعة الاستقرار وإعادة خلط الأوراق، حتى تظل الإمارات لاعبًا حاضرًا في المشهد، ولو عبر الفوضى والدم.
لقد انكشف المجلس الانتقالي بالكامل، وانكشفت الجهات التي تقف خلفه، وتبيّن بما لا يدع مجالًا للشك أنه لم يكن سوى أداة وظيفية نُفّذت بها مشاريع خارجية. وقد أُغلقت الصفقة بالفعل في سقطرى وميناء عدن، تمامًا كما حدث في ميناء بربرة، حيث قاد التدخل الإماراتي إلى إضعاف الدولة الصومالية وفتح الطريق أمام كيان انفصالي لم يعترف به أحد سوى إسرائيل، التي زارها وزير خارجيتها علنًا، فيما وجد الزبيدي فيها ملاذًا سياسيًا بدعم إماراتي فجّ لا يحتاج إلى تفسير.
إن ما يجري ليس حالة يمنية معزولة، بل نموذج متكرر لمشروع إقليمي قائم على تفكيك الدول، وإضعاف الجيوش، والسيطرة على الموانئ والممرات البحرية، وإدارة الصراعات بدل حلها. مشروع لا يرى في الشعوب سوى أدوات، ولا في السيادة سوى عائق يجب كسره.
من هنا، فإن الصمت العربي والإسلامي لم يعد مقبولًا، والتغاضي عن هذه السياسات لم يعد حيادًا بل تواطؤًا غير مباشر. إن الوقوف الحازم أمام هذا العبث لم يعد خيارًا أخلاقيًا فحسب، بل ضرورة لحماية ما تبقى من استقرار المنطقة، قبل أن تمتد النيران إلى ما هو أبعد من اليمن.

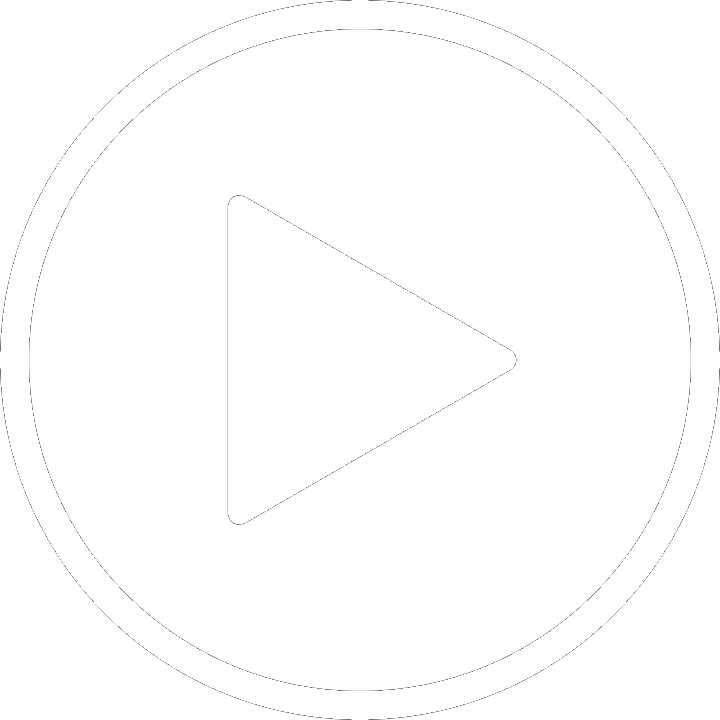
مقطع لا يسمع … بل يحس
«سنيني يم… وقلبي المركب المتعب… وأنتِ الريح».
من منّا صادف هذا المقطع من أغنية شبيه الريح ولم يتوقف عنده؟ من استطاع أن يمرّ عليه مرورًا عابرًا دون أن يكمله، أو دون أن يعيده مرةً واثنتين، وربما أكثر؟ أجرؤ على القول إن هذا المقطع يُعدّ من اروع وأقوى ما قُدّم في تاريخ الأغنية العربية الحديثة.
فمنذ اللحظة الأولى، تأخذك المقدّمة الموسيقية إلى مساحة شعورية واسعة، تمتزج فيها المتناقضات بانسجام نادر؛ حزنٌ عميق يتجاور مع فرحٍ خفي، خوفٌ قلق يلتقي بإحساسٍ بالأمان، يأسٌ يطلّ برأسه لكنه لا يلبث أن يفسح المجال للأمل والرجاء. هذا التناقض ليس تشويشًا، بل حالة إنسانية صادقة تُشبهنا، وتُشبه تقلبات القلب حين يبحر بين التعب والانتظار.
الكلمات هنا ليست مجرد شعر، بل صورة مكتملة لروحٍ أنهكها السفر، وللقلب الذي صار مركبًا متعبًا يبحث عن ريحٍ تقوده لا تكسِره. أما اللحن، فجاء وفيًّا للنص، يرفعه حينًا ويحتضنه حينًا آخر، بينما يكتمل المشهد بالأداء الذي حمل الإحساس بصدق وعمق دون افتعال.
إنه عمل ناضج، اكتمل شعرًا ولحنًا وأداءً، واستطاع أن يلامس وجدان المستمع لا لأنه جميل فحسب، بل لأنه صادق، ولأن كل عنصر فيه خُلق ليخدم الآخر، فخرج إلينا قطعة فنية متكاملة، تبقى عالقة في الذاكرة، وتُعاد كلما أردنا أن نصغي لقلوبنا قليلًا.

رئاسة اتحاد الكرة بين العاطفة والاحتراف: نواف الت...
يُعد منصب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم من أكثر المناصب حساسية وتأثيرًا في المنظومة الرياضية، لما له من انعكاس مباشر على الشارع الرياضي، والمنتخبات الوطنية، والأندية، فضلًا عن صورة الرياضة السعودية إقليميًا ودوليًا. وهو منصب لا يحتمل الارتجال أو القرارات الانفعالية، بل يتطلب شخصية تمتلك ثقافة واسعة، وخبرة تراكمية، ورؤية استراتيجية بعيدة المدى، قادرة على إدارة التفاصيل وصناعة القرار في آن واحد.
رئيس الاتحاد يجب أن يكون تكنوقراطًا حقيقيًا، يجمع بين المعرفة العلمية والتجربة العملية، ويمتلك فهمًا عميقًا للعبة من داخل الملعب وخارجه، بعد أن مارسها وعاش تفاصيلها فنيًا ونفسيًا وإداريًا. كما أن القيادة في هذا الموقع لا تُمنح بالصفة، بل تُثبت بالفعل، وتتجلى في القدرة على اتخاذ القرار الصعب في التوقيت الأصعب، دون أن تطغى العاطفة على الحكمة، أو المجاملة على المصلحة العامة.
ومن أهم متطلبات هذا المنصب القدرة على التعامل الاحترافي مع الإعلام، وامتصاص ردود الفعل الجماهيرية، دون الانجرار خلف الضغوط أو ممارسة المزايدة لكسب رضا آني. فمغازلة الشارع الرياضي قد تحقق قبولًا مؤقتًا، لكنها غالبًا ما تُفضي إلى قرارات خاطئة إذا غابت الرؤية وحضرت العاطفة، وهو ما لا تحتمله مرحلة تتطلب العمل بهدوء وثبات.
كما أن النزاهة، والحياد، والقبول العام، تمثل ركائز أساسية لا غنى عنها. وحتى وإن كانت الميول الشخصية معروفة، فإن أمانة المنصب تفرض أن تكون مصلحة الوطن، ونجاح الرياضة السعودية، وقيم المواطنة، فوق كل اعتبار، بعيدًا عن التعصب أو الانحياز لأي طرف.
وفي هذا الإطار، يبرز اسم نواف التمياط كأحد أكثر الشخصيات قبولًا لدى الشارع الرياضي، لما يحمله من رصيد فني وإنساني وإداري. فقد مارس كرة القدم على أعلى المستويات، وكان أحد أبرز نجومها، ثم انتقل بسلاسة إلى العمل الإداري والإعلامي، واكتسب خبرات متنوعة من خلال المبادرات المجتمعية والأنشطة الاجتماعية، إلى جانب شبكة علاقات واسعة داخل المملكة وخارجها. وهي منظومة خبرات متكاملة تُسهم في تشكيل قائد قادر على قراءة المشهد الرياضي بجميع أبعاده.
نواف التمياط لا يتصنع القيادة ولا الثقافة ولا الخبرة؛ فهي جزء أصيل من تكوينه وشخصيته. يتميز بهدوء متزن، ووعي عميق، وقدرة على الموازنة بين الحزم والمرونة، وبين الواقعية والطموح، بما يخدم المصلحة العليا لكرة القدم السعودية.
وتزداد أهمية هذه الصفات في المرحلة المقبلة، خصوصًا في الفترة الحساسة التي تسبق كأس العالم، حيث يُعد نواف التمياط من أكثر الأسماء قدرة على إدارة هذه المرحلة بكفاءة. فمعرفته الدقيقة باللاعبين، وقدراتهم الفنية والنفسية، وخبرته في التعامل مع الأجهزة الفنية، تمنحه ميزة حقيقية في تقييم العمل الفني، وتحليل الأداء، والتواصل الفعّال مع المدرب والخبراء، بعيدًا عن الانطباعات السطحية أو الضغوط الخارجية.
كما أن إلمامه بمفاهيم الإحلال والتجديد، ومعرفته بمن يستحق تمثيل المنتخب الوطني وكيفية الاستفادة المثلى من العناصر الحالية والمواهب الصاعدة، تجعله قادرًا على قيادة عملية البناء المرحلي للمنتخب، بما يضمن الجاهزية الفنية والذهنية لكأس العالم. إضافة إلى ذلك، فإن فهمه لمتطلبات الإعداد، وبرامج التجهيز، والتوازن بين الاستحقاقات، يمنحه القدرة على اتخاذ قرارات دقيقة تخدم الهدف الأكبر، وهو الظهور المشرف والمنافس في المحفل العالمي.
ومن هنا، فإن الحديث عن نواف التمياط لا يندرج في إطار المجاملة أو العاطفة، بل يستند إلى قراءة موضوعية لاحتياجات المرحلة. فقد يكون تعيينه خطوة جريئة نحو إحداث تغيير حقيقي في شكل ومضمون الاتحاد السعودي لكرة القدم، تغيير في الفكر قبل الأشخاص، وفي المنهج قبل العناوين، بما يتواكب مع طموحات الكرة السعودية ومكانتها المتنامية على الساحة الدولية.

الفروق بين خيسوس وإنزاغي – قراءة شمولية في الفلس�...
الاختلاف بين خيسوس وإنزاغي لا يقتصر على النتائج أو شكل الأداء داخل الملعب، بل يمتد ليشمل الفلسفة التدريبية، والمرونة التكتيكية، وإدارة اللاعبين بدنياً ونفسياً، وقدرة كل مدرب على التكيّف مع ظروف المباراة.
خيسوس يعتمد بدرجة كبيرة على لاعبين جاهزين بدنياً وذهنياً، ويقود المباراة من على الخط بتدخل مباشر ومستمر، موجهاً اللاعبين لحظياً في التحركات والتمركز. هذا الأسلوب يمنح الفريق اندفاعاً آنياً، لكنه في المقابل يرفع منسوب الضغط والإجهاد، ما يؤثر على الاستدامة ويزيد احتمالية الإصابات، خاصة مع توالي المباريات وتراكم الأحمال.
كما أن خيسوس يُظهر تشبثاً واضحاً بالنهج الكلاسيكي 4-3-3، وهي خطة ناجحة في ظروف معينة، لكنها تصبح محدودة الحلول عندما تتغير معطيات المباراة أو يُغلق الخصم المساحات. هذا الثبات التكتيكي قد يقلل من قدرة الفريق على المناورة والعودة في السيناريوهات المعقدة.
في المقابل، إنزاغي مدرب خلاق يؤمن بالمنظومة قبل الأفراد، ويعمل على رسم الجمل التكتيكية في التدريبات، مع إشراك اللاعبين في فهم الفكرة وتطبيقها داخل الملعب. يتميز بامتلاكه حلولاً متعددة وتوازناً واضحاً بين الدفاع والهجوم، ما ينعكس على استقرار الأداء وتقليل الضغط البدني.
ومن أبرز نقاط قوة إنزاغي تنوعه التكتيكي العالي؛ إذ يستطيع الانتقال بسلاسة بين عدة خطط، من 4-3-3 إلى 3-5-2، وأحياناً التبديل بينهما خلال المباراة نفسها بحسب الخصم وسير اللعب. هذا التنوع يمنح الفريق مرونة أكبر، ويجعل اللاعبين مستعدين لمختلف الاحتمالات، ويصعّب على الخصم قراءة أسلوب اللعب أو التنبؤ بردود الفعل.
تكتيكياً، يتميز إنزاغي بمرونة في بناء اللعب، حيث يمكن أن تبدأ الهجمة من أي جزء في الملعب، سواء من العمق أو الأطراف أو حتى عبر التحولات السريعة، ما يضيف بعداً إضافياً من التنوع والتهديد.
أما على مستوى العلاقة مع اللاعبين، فإن إنزاغي يُعد أكثر قرباً من الجيل الحالي، وأكثر تفهماً للجوانب النفسية والبدنية، ما يجعله أقدر على إدارة المجموعة واستثمار نقاط القوة الفردية وتقليل نقاط الضعف. في المقابل، يميل خيسوس إلى قيادة أكثر صرامة وعمودية، تركز على الانضباط والتنفيذ المباشر.

اليمن بين خيار الوحدة … و مخاوف الانفصال
يذهب بعضهم إلى الاعتقاد بأن انفصال اليمن إلى شمال وجنوب بات خيارًا سهل التحقيق، أو حلًا جاهزًا للأزمة اليمنية المركّبة، غير أن هذا الطرح يغفل تعقيدات تاريخية واجتماعية وسياسية عميقة تشكّلت عبر عقود طويلة. فبعد ما يقارب أربعين عامًا من الوحدة، لم يعد الحديث عن الانفصال مجرد قرار سياسي أو إجراء إداري، بل تحوّل إلى مسألة تمس جوهر النسيج الاجتماعي اليمني، وتحمل في طياتها عواقب خطيرة على السلم الأهلي والاستقرار الوطني والإقليمي.
وقبل قيام الوحدة، ورغم وجود كيانين سياسيين، كان اليمن في جوهره واحدًا: وحدة في الدين، واللغة، والعادات، والتقاليد، والبنية الاجتماعية. وجاءت سنوات الوحدة لتُعمّق هذا الانصهار الطبيعي، من خلال التزاوج، والمصاهرة، وتشابك المصالح الاقتصادية والاجتماعية، وتداخل الهويات المحلية، الأمر الذي جعل أي محاولة للفصل القسري بين الشمال والجنوب اليوم بالغة التعقيد، إن لم تكن مستحيلة دون أثمان إنسانية وسياسية باهظة.
ومن أبرز الشواهد على وحدة المصير، وقوف اليمنيين شمالًا وجنوبًا في مواجهة انقلاب جماعة الحوثي على الدولة والشرعية. فقد شكّل ذلك الموقف محطة مفصلية عبّرت عن إدراك جمعي بأن الخطر الذي يهدد الدولة اليمنية لا يميّز بين منطقة وأخرى. ومن هذا المنطلق، تبدو دعوات الانفصال، خصوصًا في ظل هذا السياق، موضع تساؤل أخلاقي وسياسي، لما تحمله من تنكّر لتضحيات مشتركة قدّمها أبناء اليمن في مختلف المحافظات.
وفي المقابل، لا يمكن إنكار وجود مظالم حقيقية في الجنوب، وشعور متراكم لدى قطاعات واسعة بالتهميش وسوء إدارة الدولة بعد الوحدة. وهي مظالم أسهمت في صعود حركات احتجاجية تطالب بتصحيح مسار الوحدة، أو بإعادة صياغتها على أسس عادلة. غير أن تحويل هذه المطالب المشروعة إلى مشروع انفصال يُفرض بالقوة، أو يُدار بمنطق الغلبة، يحمل مخاطر تفوق بكثير ما يُروّج له من مكاسب. فالتجارب الإقليمية والدولية تؤكد أن الانفصال في مجتمعات منقسمة لا يُنتج استقرارًا، بل يفتح الباب أمام صراعات داخلية جديدة، ويُضعف بنية الدولة، بدلًا من إصلاحها.
وفي هذا السياق، يُنظر إلى ممارسات المجلس الانتقالي الجنوبي بوصفها عاملًا إضافيًا في تعميق الانقسام داخل الجنوب ذاته. فمحاولاته فرض رؤيته بالقوة السياسية أو العسكرية أسهمت في إضعاف الجبهة الجنوبية الداخلية، وخلقت انقسامات واضحة بين أبنائه، كما هو الحال في حضرموت والمهرة، حيث تبرز مواقف رافضة لهيمنته ومخططاته. ويثير هذا الواقع مخاوف حقيقية من انزلاق اليمن إلى نماذج دول تفككت بفعل تعدد مراكز النفوذ، وغياب مشروع وطني جامع، وتحول السلاح من أداة حماية إلى وسيلة صراع داخلي.
ويزداد القلق مع استمرار محاولات المجلس الانتقالي بسط نفوذه على حضرموت والمهرة، لما لهاتين المحافظتين من أهمية جغرافية واقتصادية واستراتيجية. ولا تقتصر هذه المساعي على الأدوات العسكرية والأمنية، بل تشمل تحركات سياسية ودبلوماسية معقّدة تهدف إلى فرض أمر واقع، يتيح التفاوض من موقع قوة، داخليًا وخارجيًا، دون تفويض وطني جامع أو توافق محلي حقيقي.
وتشير بعض التحليلات إلى أن هذه التحركات تأتي ضمن مساعٍ لعقد صفقة سياسية غير معلنة مع جماعة الحوثي، تقوم على مبدأ تقاسم النفوذ: جنوب يخضع لسيطرة الانتقالي، وشمال تحت هيمنة الحوثي، مقابل إرضاء أطراف إقليمية ومحلية مؤثرة، واستخدام أدوات الضغط أو الإغراء السياسي والمالي لضمان القبول أو الصمت، حتى وإن كان ذلك على حساب القيم الوطنية والمبادئ الجامعة.
غير أن هذا المسار يطرح سؤالًا جوهريًا لا يمكن تجاهله: هل يمكن الوثوق بجماعة الحوثي، وهي حركة دينية عقائدية ذات مشروع توسعي، أن تلتزم بحدود جغرافية أو باتفاقات تقاسم نفوذ؟ فالتجربة العملية منذ حروب صعدة، مرورًا بانقلابها على الدولة، تؤكد أن الحوثي لا ينظر إلى السلطة كشراكة وطنية، بل كغنيمة، ولا يؤمن بمنطق الدولة الوطنية، بقدر إيمانه بمشروع أيديولوجي يتوسع كلما سنحت له الفرصة.
وعليه، فإن أي رهان على قبول الحوثي بدولة جنوبية مستقلة، أو بحدود فاصلة دائمة، يبدو رهانًا محفوفًا بالمخاطر، وقد يقود في نهاية المطاف إلى صراع جديد لا يقل شراسة عن الصراع القائم، بل ربما أشد تعقيدًا، لأنه سيكون صراعًا بين مشاريع مسلحة متنافسة، لا بين دولة وجماعة متمردة.
كما أن الطروحات التي تلمّح إلى تقاسم البلاد بهذا الشكل أثارت قلقًا واسعًا في الأوساط الدولية، لما تحمله من تهديد مباشر لأمن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، وللاستقرار الإقليمي عمومًا، وأسهمت في تقويض الثقة الدولية بالقيادات التي تطرحها، بدلًا من تعزيز فرص الحل السياسي الشامل.
وفي المحصلة، يظل خيار الحفاظ على وحدة اليمن، مع إجراء إصلاحات جذرية تعالج المظالم، وتعيد بناء الدولة على أسس العدالة والشراكة والإنصاف، أقل كلفة وأكثر أمانًا على المدى البعيد من خيار الانفصال. فالوحدة ليست شعارًا سياسيًا جامدًا، بل مسؤولية تاريخية تتطلب شجاعة في النقد، وصدقًا في المعالجة، وحوارًا وطنيًا جامعًا، وتغليب مصلحة اليمنيين جميعًا على المصالح الضيقة، حفاظًا على السلم والاستقرار، ومنعًا لمزيد من الانقسامات والدماء.

في وهم النتائج: لماذا لا يُبنى الصواب على الخطأ
يؤكد المنطق الرياضي، كما يؤكد علم المنطق عمومًا، حقيقةً أساسية مفادها أن الخطأ لا يمكن أن يكون أصلًا يُبنى عليه الصواب. فالنتيجة الصحيحة لا تُستنبط من مقدّمات خاطئة، حتى وإن بدا لنا أحيانًا أن ذلك قد حدث مرةً عَرَضًا. ما يظهر كصوابٍ خارج من الخطأ ليس سوى مصادفة، والمصادفة لا ترقى إلى مستوى القاعدة، ولا يمكن التعويل عليها أو تكرارها بثقة.
في المقابل، من الممكن – بل من المحتمل – أن تُفضي مقدّمات صحيحة إلى نتائج خاطئة، إذا شاب الاستدلال خلل، أو تدخل عامل خارجي، أو أُسيء التطبيق. لكن الفارق الجوهري هنا أن الصواب يملك قابلية التصحيح والمراجعة، بينما الخطأ يظل هشًا مهما طال بقاؤه.
ويمكن تشبيه هذه الفكرة بنتائج المباريات الرياضية: قد يفوز فريق ضعيف في مباراة واحدة بفعل الحظ، أو خطأ من الخصم، أو ظرف استثنائي. غير أن هذا الفوز لا يعكس بالضرورة قوة حقيقية، ولا يمكن أن يتحول إلى سلسلة انتصارات مستمرة. فالحظ قد يبتسم مرة، لكنه لا يضع نظامًا، ولا يبني استمرارية. وحدها الأسس الصحيحة — من تدريب، وانضباط، وتخطيط — هي القادرة على إنتاج نتائج متكررة ومستقرة.
بهذا المعنى، يعلّمنا المنطق أن الحقيقة ليست فيما يبدو، بل فيما يمكن تعميمه والوثوق به. فالاستثناء لا يصنع قانونًا، والنجاح العابر لا يثبت صحة المسار. وما لا يقوم على أساس سليم، قد يصمد لحظة، لكنه حتمًا ينهار مع أول اختبار جاد.
المنطق، إذن، ليس مجرد قواعد ذهنية جافة، بل هو بوصلة للحياة: يذكّرنا بأن ما نؤسس عليه أفكارنا وقراراتنا أهم من النتائج المؤقتة التي قد تخدعنا ببريقها. فالصواب الحقيقي هو ذاك القادر على الاستمرار، لا ذاك الذي يظهر صدفة ثم يتلاشى.

محترفو الأهلي: جودة منضبطة… والمفتاح بيد المدرب
لاعبو #الأهلي الأجانب، وعلى رأسهم #كيسيه و#إيفان_توني وحتى #جالينو، يمكن تصنيفهم – دون انتقاص – ضمن فئة اللاعبين التقليديين من حيث التأثير الفني داخل الملعب. هم لاعبون يؤدون ما يُطلب منهم ضمن إطار واضح، لكنهم ليسوا من النوع الذي يصنع الحل من العدم أو يكسر الجمود حين تغيب الأفكار الجماعية.
ولو وسّعنا دائرة التقييم لتشمل محترفي الفريق الأجانب كافة، سنجد أن الاستثناء الحقيقي يقتصر على #ماتيوس_غونسالفيس و#رياض_محرز؛ لاعبان يملكان القدرة على خلق الفارق، وابتكار الحلول خارج النص التكتيكي، ورفع جودة الفريق حتى في أسوأ حالاته.
أما البقية، فهم لاعبون جيدون، أدوا ما لديهم بالفعل، ولا يمكن تحميلهم مسؤوليات تتجاوز إمكاناتهم الفنية أو الذهنية. البحث عن حلول فردية إضافية عندهم هو قراءة غير دقيقة للمشهد، لأن سقف عطائهم واضح ومحدد.
من هنا، فإن جوهر المشكلة – إن وُجدت – لا يكمن في الأسماء بقدر ما يكمن في الفكرة. الحل الأمثل يقع على عاتق المدرب أولًا، عبر بناء منظومة تكتيكية واقعية تتناسب مع خصائص هؤلاء اللاعبين، وتُوظّف إمكاناتهم بالشكل الأمثل، بدل مطالبتهم بأدوار لا يجيدونها أو انتظار لحظات إبداع ليست ضمن أدواتهم الأساسية.
باختصار: اللاعبون قدموا ما يستطيعون، والفارق الحقيقي لن يأتي من مطالبتهم بالمستحيل، بل من عقل تدريبي يعرف كيف يُخرج أقصى ما لديهم ضمن حدودهم الطبيعية.

أكاديمية مهد: رهان استراتيجي لصناعة اللاعب المحل�...
هل يمكن لأكاديمية مهد أن تتحول إلى رافد استراتيجي رئيسي للأندية السعودية؟ وهل ستسهم فعليًا في الحد من الارتفاع الكبير وغير المستدام في تكاليف التعاقد مع اللاعبين الأجانب؟ والأهم من ذلك: متى سنبدأ برؤية خريجي هذه الأكاديمية يثبتون حضورهم في الفرق الأولى للأندية؟
إن إنشاء أكاديمية مهد يُعد خطوة محورية في توقيت بالغ الأهمية، خاصة في ظل القفزات الكبيرة التي شهدتها عقود اللاعبين الأجانب، سواء من حيث قيمة الانتقال أو الرواتب السنوية، إضافة إلى المخاطر المصاحبة لهذه التعاقدات. فكثير من اللاعبين الأجانب يواجهون تحديات تتعلق بالتأقلم مع البيئة المحلية، والثقافة، وأسلوب اللعب، ما ينعكس سلبًا على مستوياتهم الفنية ويجعل العائد الفني أقل من حجم الاستثمار المالي المبذول.
من هذا المنطلق، تمثل الأكاديمية فرصة حقيقية لإعادة توجيه الإنفاق من الحلول السريعة إلى الاستثمار طويل المدى في اللاعب المحلي، عبر صناعة جيل يمتلك التأهيل الفني والبدني والذهني وفق أعلى المعايير العالمية، مع فهم عميق للبيئة والثقافة المحلية. وإذا ما أُحسن ربط مخرجات الأكاديمية باحتياجات الأندية وخططها الفنية، فإنها قد تصبح سوقًا مستدامًا للمواهب، يقلل من الاعتماد المفرط على اللاعب الأجنبي، ويرفع في الوقت ذاته جودة المنافسة المحلية.
النجاح الحقيقي للأكاديمية لن يُقاس بعدد المنتسبين إليها، بل بقدرتها على ضخ لاعبين جاهزين للمنافسة في دوري المحترفين خلال السنوات القادمة، وتحقيق توازن بين الطموح الفني والانضباط المالي للأندية. عندها فقط، يمكن القول إن أكاديمية مهد لم تكن مجرد مشروع تطويري، بل حجر أساس في إعادة تشكيل مستقبل كرة القدم السعودية.

المدرب الخلّاق والملحّن الذكي: حين تتقاطع كرة الق...
في كرة القدم، لا تكمن عبقرية المدرب في التمسّك بخطة واحدة، بل في قدرته على قراءة لاعبيه واللحظة معًا. المدرب الخلّاق هو من يصنع أسلوبه من إمكانيات فريقه، ويُغيّر خططه وفق مجريات المباراة، فيصعب على الخصم توقّعه أو احتواؤه. هذه الفلسفة نفسها تحكم الموسيقى، حيث يقوم الملحّن بالدور القيادي ذاته، ويصبح المقام أداته الأساسية في إدارة المشاعر.
فالملحّن الذكي لا يتعامل مع المقام بوصفه قالبًا جامدًا، بل باعتباره فضاءً تعبيريًا واسعًا، يختار منه ما يناسب الكلمة والمعنى. كما يضع المدرب الخطة التي تُبرز نقاط قوة لاعبيه وتُخفي نقاط ضعفهم، يحرص الملحّن الواعي على أن يُغطي كل كلمة بصوتها الموسيقي المناسب، فيمنحها المقام الذي يُعبّر عن إحساسها الحقيقي.
في المقابل، يشبه الملحّن صاحب الأسلوب الواحد المدرب التقليدي الذي يفرض خطة جاهزة على لاعبيه مهما اختلفت قدراتهم. قد ينجح هذا الأسلوب في لحظة ما، ويُحقق انسجامًا ظاهريًا، لكنه سرعان ما ينكشف. فالأغنية ذات المقام الواحد تُشبه فريقًا يلعب الخطة نفسها في كل مباراة؛ واضحة، سهلة القراءة، وتفقد عنصر المفاجأة مع تكرارها.
أما الأغاني المتنوّعة في مقاماتها، فهي نتاج عقل موسيقي خلاق، يُدير الانتقالات المقامية كما يُدير المدرب تبديلاته: في التوقيت المناسب، ولغاية واضحة. هذا التنقّل لا يكون استعراضًا تقنيًا، بل ضرورة تعبيرية تُواكب تحوّلات النص وتقلبات الشعور، فتجعل المستمع شريكًا في رحلة وجدانية متكاملة.
وكما أن المدرب الذي يُجيد التنويع يبقى لغزًا تكتيكيًا يصعب فكّه، تبقى الأغنية التي يقودها ملحّن ذكي عملًا حيًا يُعاد اكتشافه مع كل استماع. فهي لا تعتمد على تأثير لحظي، بل تبني أثرًا طويل الأمد، يستقر في الذاكرة والوجدان.
في النهاية، سواء في كرة القدم أو في الموسيقى، لا يكفي الالتزام بالخطة أو بالمقام، بل الأهم هو حسن توظيفهما. فالفن، مثل اللعب الجميل، يحتاج إلى عقل يُجيد القراءة، وجرأة على التغيير، وإحساس عميق بمن يقوده.

كيف تصنع الاستثمارات والحوكمة النجاح داخل الملعب...
لم تعد الأندية الرياضية في العصر الحديث مجرد كيانات تنافسية داخل الملعب فحسب، بل تحولت إلى مؤسسات اقتصادية متكاملة تُدار بعقلية الشركات، وتخضع لمعادلات معقدة تجمع بين الأداء الرياضي والاستدامة المالية. فالنادي الذي يسعى إلى المنافسة على المدى المتوسط والطويل لم يعد قادرًا على الاعتماد على مصدر دخل واحد أو على النجاحات المؤقتة، بل بات مطالبًا ببناء منظومة متكاملة تشمل الاستثمار، والتخطيط الاستراتيجي، والإدارة الاحترافية.
من هذا المنطلق، تبرز أهمية تنويع مصادر الدخل عبر مشاريع متعددة، مثل تطوير مقرات الأندية، واستثمار الأصول العقارية، وإنشاء أكاديميات رياضية، وتوسيع قاعدة الألعاب المختلفة، إضافة إلى الشراكات التجارية وحقوق البث والرعاية. فهذه العناصر لم تعد مكملة، بل أصبحت ركائز أساسية لضمان الاستقرار المالي وتعزيز القدرة التنافسية.
كما أن ارتفاع أسعار اللاعبين وتضخم سوق الانتقالات يفرض على الأندية تبني سياسات واضحة ومدروسة في التعاقدات، تقوم على تحليل علمي للاحتياجات الفنية، والجدوى الاقتصادية، والقيمة المضافة طويلة الأمد. ولم يعد الإنفاق الكبير وحده معيار النجاح، بل حسن الاختيار، وتطوير المواهب، وبناء فرق متوازنة ضمن إطار سياسة فنية وهوية واضحة للنادي.
إضافة إلى ذلك، فإن الأندية الناجحة هي تلك التي تنظر إلى الاستثمار الرياضي بمنظور شامل، يربط بين الإنجاز داخل الملعب، والبنية التحتية، وتعدد الألعاب، والحوكمة الرشيدة، وإدارة المخاطر. فالتكامل بين هذه الأبعاد هو ما يصنع ناديًا قادرًا على المنافسة، لا فقط على البطولات، بل على الاستدامة والاستمرارية في بيئة رياضية واقتصادية شديدة التغير.

أكشن مع وليد ودوره في صناعة الجدل وتشكيل الرأي ال�...
أصبح برنامج #أكشن_مع_وليد حالة إعلامية رياضية فريدة، لا يمكن تجاوزها أو تجاهلها، حتى بات أشبه بالهواء والماء لكل رياضي ومشجع أندية على اختلاف ميولهم وانتماءاتهم. قد تتفق مع ما يُطرح فيه أو تختلف، قد تحبه أو ترفض أسلوبه، لكن المؤكد أن البرنامج فرض نفسه كجزء لا يتجزأ من مشهد #دوري_روشن، وعنصر أساسي في النقاش الرياضي اليومي.
لم يعد البرنامج مجرد مساحة تحليل أو طرح آراء، بل تحوّل إلى مصدر إلهام ومحفّز رئيسي لغالبية صنّاع المحتوى الرياضي على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تنطلق منه الأفكار، وتُبنى عليه النقاشات، وتُستكمل من خلاله موجات التفاعل والجدل. وارتباط البرنامج باسم وليد ارتباط قوي، جعل من الصعب تخيّل نجاحه أو استمراريته بذات التأثير بدونه، فالحضور والشخصية والأسلوب عناصر لا تنفصل عن هوية البرنامج.
يُعد هذا البرنامج من أبرز النماذج الإعلامية التي تنجح في خلق الجدل الإيجابي وفتح المجال أمام جميع الآراء، بطرح مشوق وأسلوب يجذب المتابع قبل المتخصص، خاصة بعد أن تجاوز نطاق المتابعة المحلية ليحظى بجمهور من خارج المملكة. ومن هنا، فإن أي حديث عن إيقاف مقدّم البرنامج – إن صحّت الأخبار – قد ينعكس بشكل مباشر على مستوى الإثارة والمنافسة في المشهد الإعلامي الرياضي، ويترك فراغًا يصعب تعويضه في المدى القريب.

مباراة المركز الثالث: الحلقة الخفية في استدامة ال...
مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع تُثار حولها دائمًا نقاشات متباينة بين من يراها مباراة شكلية بلا قيمة تنافسية حقيقية، ومن يعتبرها عنصرًا مهمًا في المنظومة الشاملة لأي بطولة كبرى. وعند النظر إليها بنظرة شمولية أعمق، تتضح أبعاد متعددة تتجاوز المستطيل الأخضر، لتشمل الجوانب الجماهيرية، والاقتصادية، والإعلامية، وحتى اللوجستية والتنظيمية.
أولًا: البعد الجماهيري واستمرارية الزخم
في البطولات الكبرى، وخصوصًا عندما لا يكون البلد المضيف طرفًا في المباراة النهائية، قد يتراجع الحضور الجماهيري ويضعف الاهتمام العام في الأيام الأخيرة. هنا تلعب مباراة المركز الثالث دورًا مهمًا في الحفاظ على الزخم الجماهيري، إذ تمنح الجماهير مباراة تنافسية إضافية، وغالبًا ما تكون مفتوحة فنيًا وأقل تحفظًا من النهائي. هذا يسهم في إبقاء الجمهور متفاعلًا ومتحمسًا حتى اليوم الختامي، ويمنع ما يمكن تسميته بـ"الفراغ العاطفي" الذي قد يسبق النهائي.
ثانيًا: البعد الاقتصادي والاستثماري
اقتصاديًا، تشكل هذه المباراة فرصة إضافية لتحقيق عائدات مالية. بيع التذاكر، حقوق البث، الإعلانات، والرعايات المرتبطة بالمباراة تمثل مصادر دخل لا يُستهان بها. كما أن بقاء الجماهير لفترة أطول يعني إنفاقًا أكبر على الإقامة، النقل، المطاعم، والتسوق، وهو ما يعود بالنفع المباشر على اقتصاد المدينة أو الدولة المستضيفة. وفي بطولات مثل كأس العالم أو البطولات القارية، قد تكون هذه العوائد جزءًا من مبررات الجدوى الاقتصادية للبطولة ككل.
ثالثًا: تسيير الرحلات والبنية اللوجستية
من زاوية تنظيمية ولوجستية، تساعد مباراة المركز الثالث على توزيع حركة السفر والمغادرة بشكل أكثر توازنًا. فبدل مغادرة أعداد كبيرة من الجماهير والصحافة فور خروج منتخباتهم من نصف النهائي، تمنحهم هذه المباراة سببًا للبقاء، ما يقلل الضغط المفاجئ على المطارات ووسائل النقل. كما تتيح لشركات الطيران والفنادق تخطيطًا أفضل للجداول والأسعار، بدل الاعتماد على ذروة واحدة مرتبطة بالنهائي فقط.
رابعًا: بقاء الصحافة والإعلام وتغطية البطولة
إعلاميًا، تمثل المباراة مادة إضافية للتغطية والتحليل والقصص الصحفية. بقاء منتخبات كبيرة أو نجوم بارزين في مباراة تحديد المركز الثالث يعني استمرار اهتمام وسائل الإعلام العالمية، وبالتالي الحفاظ على مستوى التغطية حتى آخر يوم. هذا ينعكس إيجابًا على صورة البطولة وانتشارها الإعلامي، ويمنح الصحفيين مساحة أوسع لتقديم محتوى تحليلي، إنساني، وتقييمي شامل للبطولة.
خامسًا: البعد الرياضي والرمزي
رياضيًا، لا يمكن إغفال أن تحقيق المركز الثالث قد يحمل قيمة معنوية وتاريخية للمنتخبات، خصوصًا تلك التي لا تمتلك سجلًا حافلًا بالإنجازات. ففي كثير من الأحيان، يُخلَّد المركز الثالث في الذاكرة الجماعية للجماهير والاتحادات، وقد يؤثر على التصنيف الدولي، الدعم الحكومي، وحتى مسار جيل كامل من اللاعبين.
خلاصة
مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ليست مجرد مباراة إضافية يمكن الاستغناء عنها، بل هي حلقة مكملة في منظومة البطولة الشاملة. أهميتها تتجلى بشكل أوضح عندما لا يكون البلد المضيف حاضرًا في النهائي، حيث تساهم في الحفاظ على الزخم الجماهيري، تعظيم العوائد الاقتصادية، دعم التوازن اللوجستي، واستمرار التغطية الإعلامية. ومن هذا المنطلق، فإن تقييم جدواها يجب أن يتم من منظور شامل لا يقتصر على القيمة الفنية المباشرة، بل يشمل الأبعاد الاقتصادية، التنظيمية، والإعلامية التي تُسهم في نجاح البطولة ككل.

الوطنية ليست أداة للتحريض
أحيانًا لا يكون الصمت ضعفًا، بل يكون موقفًا أخلاقيًا راقيًا. فالناس المحترمون قادرون على فرض الصمت حين يتعمّد أحمق الإساءة، لا لشخص بعينه، بل لأمةٍ كاملة، محاولًا استغلال مفاهيم الوطنية لإثارة الغوغاء وتأجيج المشاعر.
وعندما يتدخل العقلاء لإخماد عود ثقاب صغير قبل أن يتحول إلى حريق، فهم لا يفعلون ذلك خوفًا أو تراجعًا، بل حرصًا على بقاء الود بين الشعوب، ومنعًا لانزلاق الخطاب إلى مستنقع السبّ والشتم والتجريح المتبادل. هؤلاء لا يدافعون عن إساءة، بل يحافظون على القيم وصورة الحوار الناضج. ولهذا فإنهم يستحقون كل الاحترام والتقدير.
وقبل كل ذلك، لا بد من توجيه الشكر للمستشار تركي آل الشيخ، الذي أوضح للشعب المصري العظيم حقيقة فيلم الست، مؤكدًا أنه عمل مصري خالص 100٪ من حيث الفكرة والتأليف والسيناريو والتمثيل. وهذا التوضيح لا يعني بأي حال من الأحوال أن الفيلم لم يحاكِ سيرة كوكب الشرق، بل جاء لإنهاء الجدل المفتعل واللجاج غير المبرر حول هويته.
كما أن من المهم التذكير بأن أي عمل فني، قبل عرضه على الجمهور، يمر عبر دائرة ضيقة من الخبراء والمختصين الذين يقومون بنقده وتقييمه وإجازته للعرض من عدمه، وقد أُجيز الفيلم رسميًا من الجهات المسؤولة. وعليه، فإن الاعتراضات التي قد تصدر بدوافع شخصية — ككون بعض الأسماء لم تكن ضمن المستشارين — لا تعني بالضرورة أن العمل سيئًا، بل تعكس خلافات فردية لا ينبغي تحميلها أكثر مما تحتمل.
وفي هذا السياق، تمثل ياسمين عز و قبلها المحامي خالد ابو بكر و عقلاء مصريين نموذجًا لاختيار الحكمة وضبط النفس، وتقديم صوت العقل على ضجيج الفتنة، وهو ما نحتاجه اليوم أكثر من أي وقت مضى.

خارج دائرة التعصب: مقاربة موضوعية لاختيار أعظم لا...
أثار الجدل حول هوية أفضل لاعب سعودي في تاريخ كرة القدم مساحة واسعة من النقاش على وسائل التواصل الاجتماعي، دون الوصول إلى إجماع أو اعتراف عام باسم واحد يحظى بتوافق الجميع. ومع أن غالبية المقارنات تنحصر بين أسطورتين كبيرتين هما ماجد عبدالله وسالم الدوسري، إلا أن هذا الجدل غالبًا ما يبقى أسير العاطفة والانتماء للأجيال المختلفة، أكثر من كونه قائمًا على تقييم موضوعي شامل.
ومن هذا المنطلق، يمكن طرح فكرة أكثر عدالة وعمقًا، تقوم على تشكيل لجنتين مستقلتين: الأولى من أنصار ماجد عبدالله، والثانية من أنصار سالم الدوسري. تتولى كل لجنة إعداد مادة مرئية احترافية، لا تقل عن ساعة، تستعرض أبرز ما قدمه اللاعب على المستطيل الأخضر، من إنجازات فردية وجماعية، لحظات حاسمة، تأثير فني، وأرقام موثقة، مع مراعاة السياق الزمني لكل حقبة كروية.
بعد ذلك، تُعرض هذه المواد على لجنة تحكيم محايدة من خبراء كرة قدم ومحللين من خارج الوطن العربي، ممن لا تربطهم علاقة عاطفية أو ثقافية بالكرة السعودية، ليقوموا بالتقييم والتصويت وفق معايير واضحة مثل التأثير، الاستمرارية، الإنجازات، والموهبة الفردية.
مثل هذا الطرح لا يهدف فقط إلى حسم الجدل، بل يسهم في توثيق تاريخ الكرة السعودية، ويحوّل النقاش من صراع جماهيري إلى حوار رياضي راقٍ، يعترف بقيمة الرموز المختلفة ويمنح كل جيل حقه في التقدير، بعيدًا عن التعصب والمقارنات السطحية.

المجلس الانتقالي الجنوبي بين مشروع التمثيل ومخاط...
يرى كثيرون أن ما يشهده الجنوب اليوم يعكس مسارًا خطيرًا يعيد إنتاج نماذج الصراع الداخلي، حيث يُنظر إلى قيادة المجلس الانتقالي، وعلى رأسها عيدروس الزبيدي، بوصفها عاملًا دافعًا نحو الاقتتال والحرب الأهلية، على نحو يُشبه تجارب قوى مسلحة أخرى في الإقليم أدخلت مجتمعاتها في دوامات صراع لا تنتهي.
فبعد أن كانت الشرعية تُقدَّم – نظريًا وعمليًا – كحكومة لكل اليمن، جاء المجلس الانتقالي بمشروع سياسي وعسكري يسعى إلى تفكيك هذه الشرعية من الداخل، لا من باب الإصلاح أو الشراكة الوطنية، بل لخدمة أجندة خاصة ومصالح ضيقة، مدعومة بعوامل خارجية واضحة. ويُطرح مفهوم “إدارة شؤون المحافظات بواسطة أبنائها” بوصفه حلًا مرحليًا، لكنه في الواقع – وفق هذا الطرح – ليس إلا خطوة مؤقتة لتمزيق بنية الدولة، تمهيدًا لإحكام السيطرة على مفاصل القرار، قبل أن تصبح تلك المحافظات نفسها خارج دائرة الفعل والتأثير، وكأن حكمها أُودِع “ذمة التاريخ”.
الأحداث على الأرض تُظهر أن المجلس الانتقالي، بينما يرفع شعارات تمكين الجنوب، يواصل الاستفادة من موارد البلاد، في وقت تنشغل فيه المحافظات بصراعات السلطة المحلية، وتغيب فيه الرؤية التنموية الشاملة. ويتجلى ذلك في تعطيل الموانئ والمنشآت الحيوية في الجنوب، وهو ما يطرح تساؤلًا جوهريًا: من المستفيد الحقيقي من شلّ هذه المرافق التي تُعد شريانًا اقتصاديًا للمنطقة وسكانها؟
الأخطر من ذلك أن تداول أفكار تتعلق بالتنسيق أو التعاون مع جماعة الحوثي، ولو على مستوى الطرح أو الإيحاء، يكشف عن حالة ضعف سياسي وعسكري، عند الطرفين ويعكس استعدادًا لتجاوز الثوابت الوطنية في سبيل البقاء. كما يدل على إدراك داخلي بأن المشروع الانتقالي قد لا يصمد أمام اتحاد جنوبي واسع ضده، لا سيما في مناطق مثل حضرموت والمهرة، التي أظهرت مواقف مستقلة ورافضة للوصاية.
وتؤكد تجارب السنوات الماضية أن المجلس الانتقالي لا يتردد في استخدام القوة متى ما توفر السلاح والدعم الخارجي، حتى وإن كان ذلك موجّهًا ضد أبناء الجنوب أنفسهم. وقد شكّلت المواجهات التي استهدفت قوات الشرعية، وما رافقها من عمليات وُصفت بالغدر، جرحًا عميقًا في الوعي الجمعي، يصعب تجاوزه أو تبريره سياسيًا، وهو ما جعل قبول المجلس الانتقالي شعبيًا محل شك واسع.
يُضاف إلى ذلك أن البنية الاجتماعية والسياسية للمجلس الانتقالي تُتهم بالضيق وعدم التمثيل الحقيقي للتنوع الجنوبي، حيث يُنظر إليه باعتباره متمركزًا حول مكون قبلي محدد، الأمر الذي أفقده القدرة على ادعاء تمثيل الجنوب بكل أطيافه وقواه.
في المحصلة، فإن مسار الأحداث يشير إلى أن المشروع الانتقالي، بدل أن يكون عامل توحيد وبناء، أسهم في تعميق الانقسام، وإضعاف مؤسسات الدولة، وفتح الباب أمام صراعات داخلية قد يدفع الجنوب ثمنها طويلًا، ما لم تُستعاد لغة الشراكة الوطنية، وتُقدَّم مصلحة الناس والدولة على حساب السلاح والأجندات الضيقة.

الجغرافيا أولًا: حدود التدخل، ووهم تصدير الأجندا�...
تتكوّن دولة الإمارات العربية المتحدة من سبع إمارات: أبوظبي، دبي، الشارقة، الفجيرة، عجمان، رأس الخيمة، وأم القيوين. وقد نشأ هذا الكيان الاتحادي عبر مسار سياسي بالغ الحساسية، بدأ عام 1968، وتوّج بإعلان الاتحاد عام 1972، ثم تعزّز بتوحيد القوات المسلحة عام 1976. ولم يكن هذا التوحيد تفصيلًا إداريًا، بل استجابة مباشرة لهواجس التفكك، ومحاولة واعية لتحصين كيان اتحادي وُلد في بيئة إقليمية مضطربة، كانت ولا تزال تعجّ بالانقسامات والانهيارات.
اليوم، يواجه الاتحاد الإماراتي تحديًا بنيويًا لا يمكن تجاهله: تركيبة سكانية مختلّة بعمق، إذ يشكّل المواطنون الإماراتيون نحو 11% فقط من إجمالي السكان البالغ عددهم قرابة 11 مليون نسمة. وهذا الواقع لا يُعدّ مسألة ديموغرافية عابرة، بل إشكالية سيادية تمسّ جوهر الدولة، وهوية المجتمع، واستدامة العقد السياسي على المدى الطويل.
وانطلاقًا من هذه الهواجس، تبنّت أبوظبي، بوصفها مركز القرار والثقل السياسي، سياسات انفتاح اقتصادي وديموغرافي واسع، خصوصًا في أبوظبي ودبي، ما أدّى إلى تركّز غير مسبوق للثروة والنفوذ في هاتين الإمارتين. غير أن هذا التركّز لم يكن بلا كلفة، إذ خلق فجوة داخلية واضحة، وحوّل بعض الإمارات الأخرى إلى أطراف ملحقة اقتصاديًا، رغم أنها كيانات سياسية ذات تاريخ وشرعية اجتماعية عميقة، يحكمها شيوخ ينتمون إلى أسر مؤسسة، لا إلى إدارات وظيفية.
إن تجاهل هذا الاختلال، أو التقليل من مخاطره، يُعدّ قصر نظر استراتيجي. فالاتحادات لا تُدار بمنطق المركز المتغوّل والأطراف الصامتة، بل بمنطق الشراكة المتوازنة. وأي شعور مستدام بالتهميش أو التفاوت في النفوذ قد يعيد، عاجلًا أو آجلًا، طرح أسئلة محرّمة حول معنى الاتحاد وحدوده، وهي أسئلة لا تُعالج بالقوة الاقتصادية ولا بالردع الأمني، بل بالعدالة السياسية.
في هذا السياق، يصبح التدخل الإماراتي في الشأن اليمني – ولا سيما دعم مشاريع سياسية ذات طابع انفصالي – مفارقة صارخة. فكيف لدولة اتحادية قامت أساسًا لمواجهة خطر التفكك، أن تنخرط في تغذية نزعات التفكك خارج حدودها؟ وكيف لمن يخشى على وحدته الداخلية أن يغامر بتطبيع الانقسام كأداة سياسية في دولة أخرى ذات سيادة؟
اليمن ليست دولة حدودية مباشرة مع الإمارات، ولا تشكّل امتدادًا جغرافيًا عضويًا لها، ما يجعل هذا التدخل تجاوزًا صريحًا لمنطق الجغرافيا السياسية، ومساسًا بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. فالقضايا المصيرية، كالوحدة أو الانفصال أو شكل الدولة، لا تُقرَّر عبر التمويل أو التسليح أو الرعاية السياسية الخارجية، بل عبر إرادة وطنية جامعة تعبّر عن الشعب اليمني نفسه، لا عن توازنات إقليمية عابرة.
ومن منظور أكثر صرامة، فإن إدارة أزمات الجوار يجب أن تنطلق من قاعدة واضحة: الدول الحدودية هي الأَولى بتحمّل عبء الحل، لا الدول البعيدة جغرافيًا. فالجغرافيا ليست رأيًا سياسيًا، بل قدرًا استراتيجيًا. ويظهر هذا المبدأ بجلاء في القضية الفلسطينية، حيث تقع المسؤولية المباشرة – سياسيًا وأمنيًا وإنسانيًا – على عاتق دول الطوق، وفي مقدمتها الأردن ومصر ولبنان، بحكم الحدود، واللاجئين، والتداخل السكاني، وتأثير أي انفجار في الصراع على أمنها القومي.
أما الدول البعيدة، سواء في المغرب العربي أو الخليج أو حتى في العالم الإسلامي الأوسع، فليس من حقها فرض مقاربات أو شعارات أو ضغوط سياسية على دول الطوق، ولا الزجّ بها في مغامرات تتجاهل تعقيدات الواقع الذي تعيشه هذه الدول يوميًا. فالتضامن لا يعني الوصاية، والدعم لا يبرّر فرض الأجندات.
إن دعم النزعات الانفصالية خارج الحدود، تحت أي ذريعة كانت، يضرب أسس النظام الإقليمي، ويقوّض مبدأ السيادة، ويخلق سوابق خطيرة سرعان ما ترتدّ على أصحابها. فلا يمكن لدولة أن تطالب بتحصين وحدتها الداخلية، ثم تسعى في الوقت ذاته إلى تفكيك دول أخرى. فالتاريخ لا يكافئ من يلعب بالنار، والجغرافيا لا تنسى.

مقطع لا يسمع… بل يحس
«سنيني يم… وقلبي المركب المتعب… وأنتِ الريح».
من منّا صادف هذا المقطع من أغنية شبيه الريح ولم يتوقف عنده؟ من استطاع أن يمرّ عليه مرورًا عابرًا دون أن يكمله، أو دون أن يعيده مرةً واثنتين، وربما أكثر؟ أجرؤ على القول إن هذا المقطع يُعدّ من اروع وأقوى ما قُدّم في تاريخ الأغنية العربية الحديثة.
فمنذ اللحظة الأولى، تأخذك المقدّمة الموسيقية إلى مساحة شعورية واسعة، تمتزج فيها المتناقضات بانسجام نادر؛ حزنٌ عميق يتجاور مع فرحٍ خفي، خوفٌ قلق يلتقي بإحساسٍ بالأمان، يأسٌ يطلّ برأسه لكنه لا يلبث أن يفسح المجال للأمل والرجاء. هذا التناقض ليس تشويشًا، بل حالة إنسانية صادقة تُشبهنا، وتُشبه تقلبات القلب حين يبحر بين التعب والانتظار.
الكلمات هنا ليست مجرد شعر، بل صورة مكتملة لروحٍ أنهكها السفر، وللقلب الذي صار مركبًا متعبًا يبحث عن ريحٍ تقوده لا تكسِره. أما اللحن، فجاء وفيًّا للنص، يرفعه حينًا ويحتضنه حينًا آخر، بينما يكتمل المشهد بالأداء الذي حمل الإحساس بصدق وعمق دون افتعال.
إنه عمل ناضج، اكتمل شعرًا ولحنًا وأداءً، واستطاع أن يلامس وجدان المستمع لا لأنه جميل فحسب، بل لأنه صادق، ولأن كل عنصر فيه خُلق ليخدم الآخر، فخرج إلينا قطعة فنية متكاملة، تبقى عالقة في الذاكرة، وتُعاد كلما أردنا أن نصغي لقلوبنا قليلًا.



